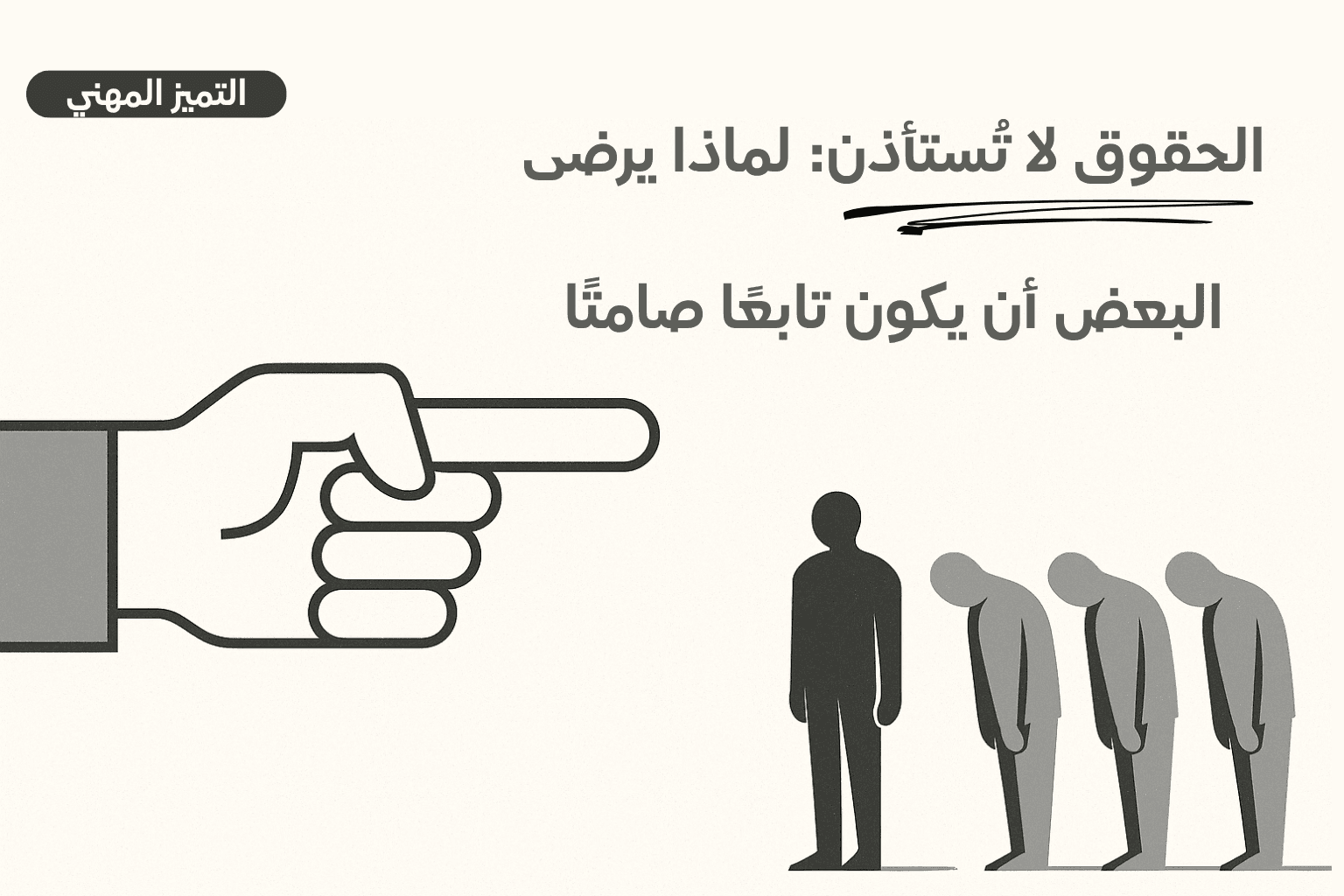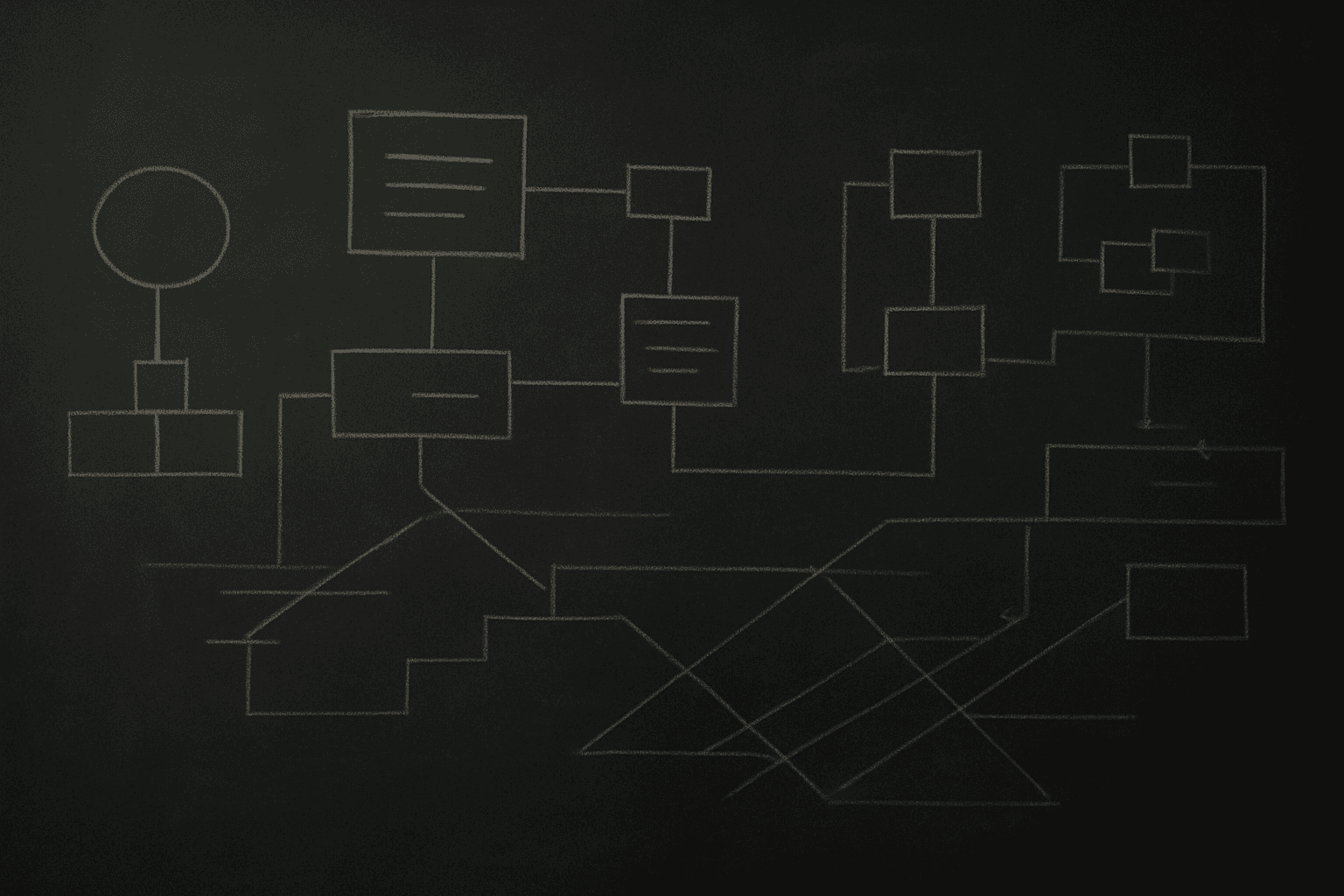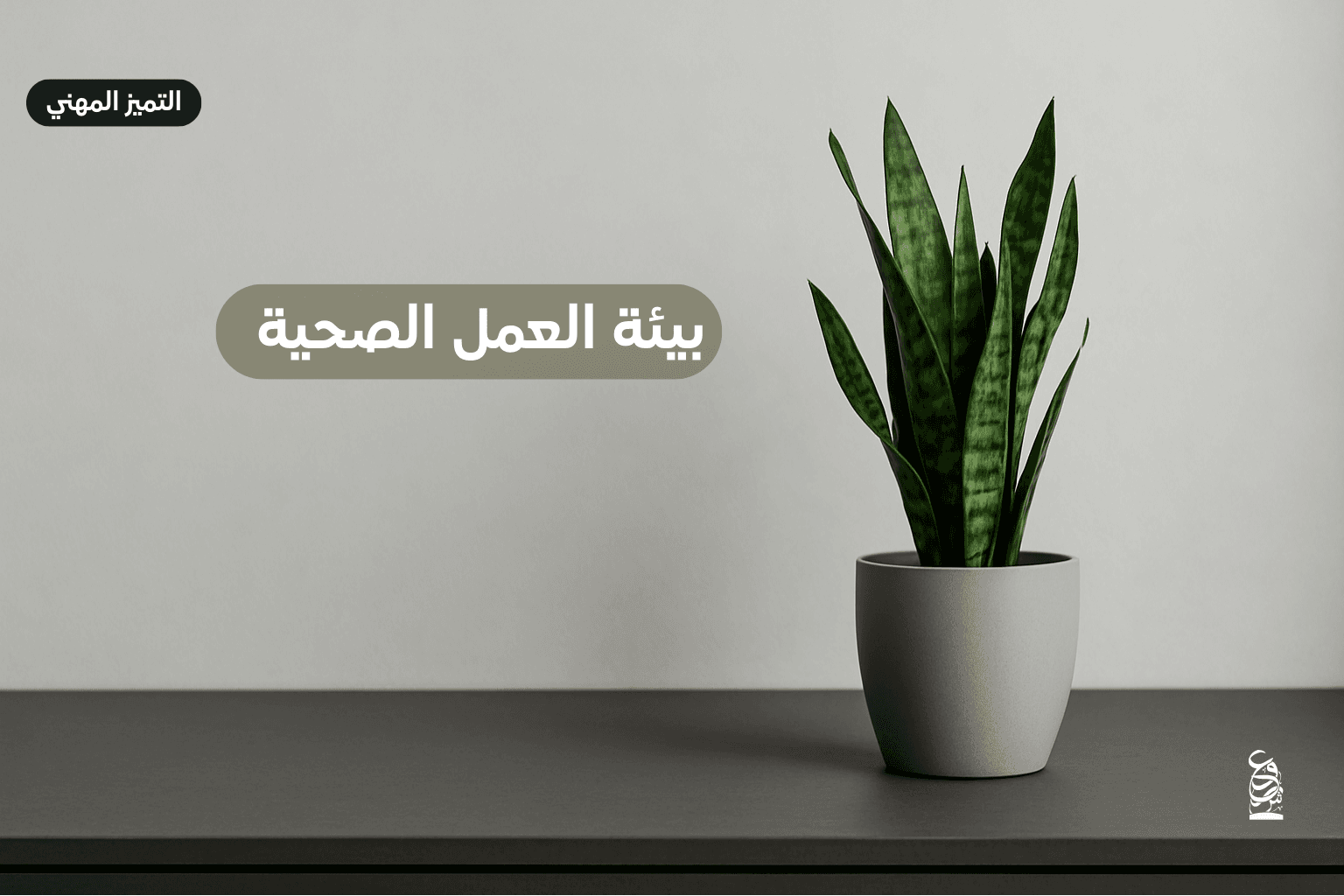في أحد المكاتب الصاخبة بالمهام، جلس موظف يتابع شاشته بتركيز، بينما كانت عيناه في الحقيقة تلاحقان حوارًا داخليًا لا ينتهي. فقد واجه موقفًا بدا بسيطًا للآخرين، لكنه بالنسبة له كان امتحانًا صعبًا: هل يتحدث عن حقه أم يصمت ويمضي كأن شيئًا لم يكن؟
القصة لم تكن عن امتياز مالي أو مطلب إضافي، بل عن أمر عادي يضمنه النظام ويُفترض أن يكون بديهيًا. ومع ذلك، اختار أن يبتلع صوته. هنا يبدأ السؤال: لماذا يرضى البعض أن يكون تابعًا صامتًا حتى أمام أبسط حقوقه؟
حكاية الموظف الصامت
ذلك الموظف كان يعمل منذ سنوات في نفس المؤسسة. يعرف تفاصيل اللوائح كما يعرف تفاصيل مكتبه، ويعي جيدًا ما هو حق وما هو فضل. لكنه كان كلما وجد نفسه أمام موقف يتطلب أن يطالب، يفضّل أن يطوي الأمر في داخله. يبرر ذلك بأنه "لا يريد مشاكل"، أو "يريد أن يكون محبوبًا"، أو أن "الصمت أحيانًا أذكى من الكلام".
مع مرور الوقت، لم يعد الأمر مجرد موقف عابر. صار عادة راسخة. أصبح يبرر لنفسه التنازل عن حق تلو الآخر حتى صارت المسألة أشبه بتربية ذاتية على الخضوع. وحين التفت حوله، وجد أن صمته لم يجلب له التقدير كما كان يتوقع، بل رسّخ صورة أنه الشخص الذي يقبل بأي شيء.
الخضوع الذي يولّد الاستغلال
حين يصمت الموظف عن حقه، يفتح الباب لبيئة كاملة من الاستغلال. ليس لأن الإدارة بالضرورة تنوي الظلم، بل لأن الصمت يُفسَّر في الغالب على أنه رضا. ومع تكرار المواقف، يصبح هذا الرضا المفترض أساسًا للتعامل. ومن هنا يولد الخلل: ليس من النظام ولا من المؤسسة وحدها، بل من ثقافة الخنوع التي يمارسها بعض الموظفين على أنفسهم.
في هذه اللحظة، يتحول الموظف إلى جزء من المشكلة بدل أن يكون جزءًا من الحل. فهو لا يواجه الظلم ولا يضع حدودًا واضحة، بل يترك نفسه رهينة لتأويلات الآخرين. وهكذا تتكرس حلقة مفرغة: خضوع يولّد استغلالًا، واستغلال يعزز خضوعًا.
لماذا نصمت عن حقوقنا؟
الجواب ليس واحدًا، لكنه يبدأ غالبًا من الخوف. الخوف من فقدان الرضا، الخوف من النظرة السلبية، الخوف من أن يُحسب صوت المطالبة تمردًا. وهناك أيضًا عقدة "الرضا بالقليل"، حين يقنع الإنسان نفسه أن التنازل نوع من الحكمة أو التواضع، بينما هو في الحقيقة ضعف ينهش قيمته تدريجيًا.
المدهش أن هذا الصمت قد لا يحمي الموظف أصلًا، بل على العكس، قد يجعله في موضع الاستبعاد عند أي فرصة. فالمؤسسات لا تراهن على من لا يرى نفسه مستحقًا، بل على من يعرف قيمته ويعبّر عنها باحترام ووضوح.
أثر الصمت على البيئة المؤسسية
لا يقتصر الأمر على الفرد. بيئة العمل التي يكثر فيها الصامتون تتحول تدريجيًا إلى بيئة مثقلة باللامبالاة. الموظف الذي يسكت عن حقه اليوم، يرسل رسالة ضمنية لزملائه بأن السكوت أفضل من الكلام. وهكذا تنتشر عدوى الخضوع حتى تصبح ثقافة عامة.
والنتيجة؟ مؤسسة تبدو مستقرة من الخارج لكنها هشة من الداخل. إنتاجية ضعيفة، ولاء منخفض، وإحساس عام بالظلم ينعكس في كل تفصيلة صغيرة. بينما الحقيقة أن التغيير لم يكن يحتاج إلى قرارات كبرى، بل إلى أصوات صغيرة ترفض الصمت وتتمسك بما هو حق.
المطالبة ليست تمردًا
ثمة خلط كبير بين المطالبة بالحق وبين التمرد. المطالبة هي ممارسة طبيعية، يقوم بها الموظف الواعي بأسلوب راقٍ يوازن بين الصراحة والاحترام. هي إعلان أن العلاقة بين الموظف وصاحب العمل ليست علاقة تبعية عمياء، بل علاقة قائمة على الوضوح والتوازن.
ولذلك، فالمؤسسات التي تنجح حقًا ليست تلك التي تسكت الأصوات، بل تلك التي تتيح لها أن تُسمع. لأن الوعي بالحق لا يقل أهمية عن الالتزام بالواجب.
الدرس الأعمق
حين ننظر إلى الموظف الصامت في قصتنا، لا نرى مجرد فرد تنازل عن موقف. نرى صورة أوسع: صورة مجتمع صغير داخل المؤسسة يختبر توازنه بين الحقوق والواجبات. فإذا سكت الجميع، اختل الميزان. وإذا تجرأ البعض على المطالبة، استعاد الميزان توازنه.
وهنا يظهر الدرس الأعمق: الحقوق لا تُستأذن. هي ليست هدية تُعطى لمن يُحسن الصمت، وليست ورقة تفاوض لمن يجيد المساومة. الحقوق تُمارَس ببساطة، بوعي وكرامة، دون خوف أو خنوع.
خاتمة
الصمت قد يبدو خيارًا مريحًا في لحظته، لكنه في الحقيقة أثقل كلفة من الكلام. لأن الموظف الذي يعتاد أن يكون تابعًا صامتًا يخسر شيئًا أكبر من حقه: يخسر صورته أمام نفسه.
ويبقى السؤال معلقًا: هل المشكلة في الإدارة التي تضغط… أم في الموظف الذي اختار أن يصمت ويظلم نفسه قبل أن يظلمه الآخرون؟